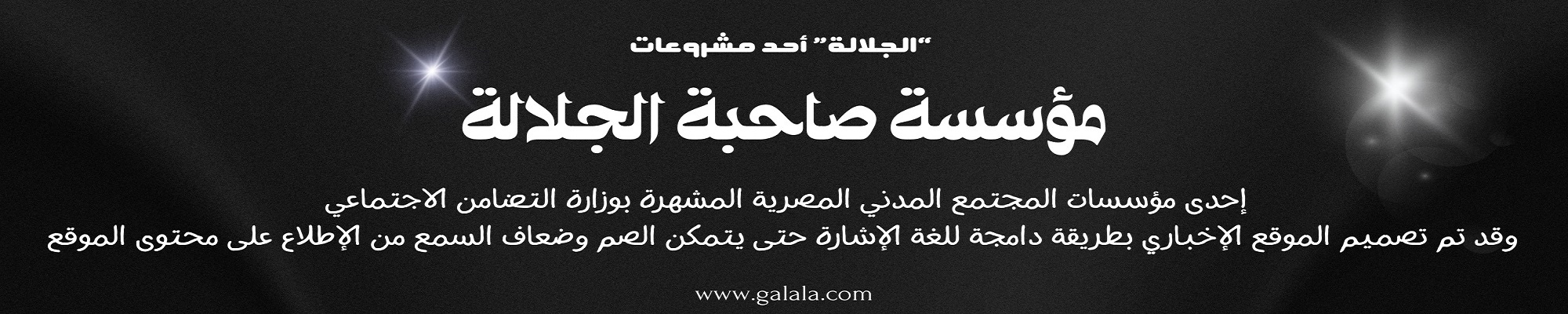من جيب المواطن.. إلى انهيار المجتمع

في بلادٍ تعرف الشمس منذ فجر التاريخ، صار ظل المواطن أقصر من حلمه، وجيبه أعمق من أن يُملأ، لكنه دائمًا أوّل من يُفتَّش فيه، وكأن التنمية لا تبدأ إلا من محفظته، ولا تُبنى إلا على كتفيه المنحنية من ثقل الفواتير. هنا، تُصبح الورقة الرسمية أغلى من رغيف الخبز، والختم الحكومي أثمن من دواء طفل، ويُعامل المواطن لا كمستفيد من الخدمة، بل كممول دائم لها، شاء أم أبى.
دولة تعاني من عجز مزمن في الموازنة وارتفاع متواصل في كلفة التشغيل، لم تجد بعض القطاعات الحكومية الخدمية الاقتصادية طريقًا أسهل لزيادة مواردها من المواطن نفسه. وكأن المواطن ــ لا النفط أو السياحة أو الاستثمارــ صار المصدر الأضمن والجاهز للدخل السريع.
على مدار السنوات الأخيرة، شهدنا موجات متتابعة من زيادة الرسوم على المستخرجات الرسمية والخدمات الحكومية، الأمر لم يعد مقصورًا على ضريبة أو جمارك أو “دمغة” قديمة؛ بل صار يشمل تفاصيل كانت حتى وقت قريب مجانية أو رمزية، ورقة مطبوعة في أحد المصالح الحكومية قد تصل رسوم تصويرها إلى 10 جنيهات للورقة الواحدة! وفي مصالح أخرى، شهادة الميلاد أو القيد العائلي التي كانت تكلف بضع جنيهات، أصبحت تتجاوز العشرين أو الثلاثين، وأحيانًا أكثر إذا أضفت رسوم “الإلكتروني” و”الخدمة العاجلة”!
قد يبدو المبلغ زهيدًا على الورق، لكنه بالنسبة لصاحب المعاش الذي يتقاضى 1500 أو 2000 جنيه، أو الموظف الذي لا يتجاوز مرتبه 3000 جنيه، يصبح الأمر كمن يثقب قاربًا صغيرًا وسط بحر هائج، فالمواطن محدود الدخل لا يتعامل مع الرسوم كحالات منفصلة، بل كـ”كرة ثلج” تتدحرج وتكبر؛ فاتورة كهرباء أعلى، مياه أغلى، رسوم تعليم، رسوم طبية، ورسوم ورقية وإدارية لا تنتهي.
في المقابل، نجد أن صاحب المشروع الحرفي أو التجاري لديه هامش للمناورة؛ إذا ارتفعت كلفة مواده الخام أو إيجار محله، يرفع سعر الخدمة أو السلعة، ويعوض الفارق من جيب المستهلك! صحيح أنه قد يواجه عزوفًا من بعض الزبائن، لكن طبيعة السوق تضمن أن يجد من يشتري أو يتعامل معه، فيخرج في النهاية رابحًا أو على الأقل متعادلًا.. أما الموظف، أو صاحب المعاش، فهو لا يملك هذه الرفاهية؛ دخله ثابت، والغلاء متحرك صعودًا فقط.
ولعل المشهد الأكثر قسوة أن ترى مواطنًا في الستين من عمره، عمل لثلاثة عقود، يجلس في طابور طويل أمام شباك خدمة، يخرج من جيبه ورقة مالية لا يتبقى بعدها سوى فتات ليكمل الشهر، أو شابة تعمل 20 ساعة يوميًا بين وظيفة صباحية ومشروع منزلي ليغطي دخلها إيجار السكن وفواتير الخدمات، بينما أحلامها الشخصية تتساقط واحدًا تلو الآخر، من شراء سيارة، استكمال دراسة، أو حتى إجازة بسيطة.
تدرك الدولة أن كل خدمة لها تكلفة، وأن تحديث الأنظمة وتطوير البنية التحتية يحتاج تمويلًا، لكن المشكلة حين يصبح المواطن البسيط هو “الخزنة” الوحيدة التي تُفتح وقت الحاجة، والأخطر أن هذه السياسة ليست مؤقتة أو استثنائية، بل تتوسع عامًا بعد عام، حتى بات المواطن نفسه سلعة يُستثمر فيها؛ كل معاملة ورقية، كل توقيع، كل ختم.. له ثمن.
إذا استمر هذا المسار، سنجد أن الفارق بين صاحب الدخل الثابت وبقية فئات المجتمع لن يكون فقط في مستوى المعيشة، بل في قدرته على أداء أبسط الإجراءات الإدارية، الفقر حينها لن يكون فقط عجزًا عن شراء سلعة أو خدمة، بل عجزًا عن إثبات وجودك على الورق!
النهارده، المواطن البسيط مش بيحسب بس إيجار البيت وفاتورة الكهرباء، ده بيحسب كمان كل شباك هيمر عليه في أي مصلحة حكومية، بيحسب كل ورقة بقت “حكاية”، وكل ختم بقى “مصاريف”، وأي زيادة في الرسوم الحكومية معناها خصم مباشر من أحلامه قبل جيبه.
أما أصحاب المعاشات، فأمرهم أدهى؛ معاش ثابت لا يزيد إلا على استحياء، يقابله ارتفاع في الرسوم والخدمات كمن يسابق القطار وهو مقيد! أي حساب منطقي يقول إن هذه المعادلة عادلة، بل وقابلة للاستمرار!
ربما آن الأوان لإعادة النظر في فلسفة “تمويل الخدمات عبر جيب المواطن”، والبحث عن حلول مبتكرة لزيادة موارد القطاعات الحكومية دون سحق الطبقة الكادحة، فالضغط على نفس الشريحة بلا توقف لا يؤدي إلا إلى شيء واحد: انهيارها، ومعها ينهار المجتمع.